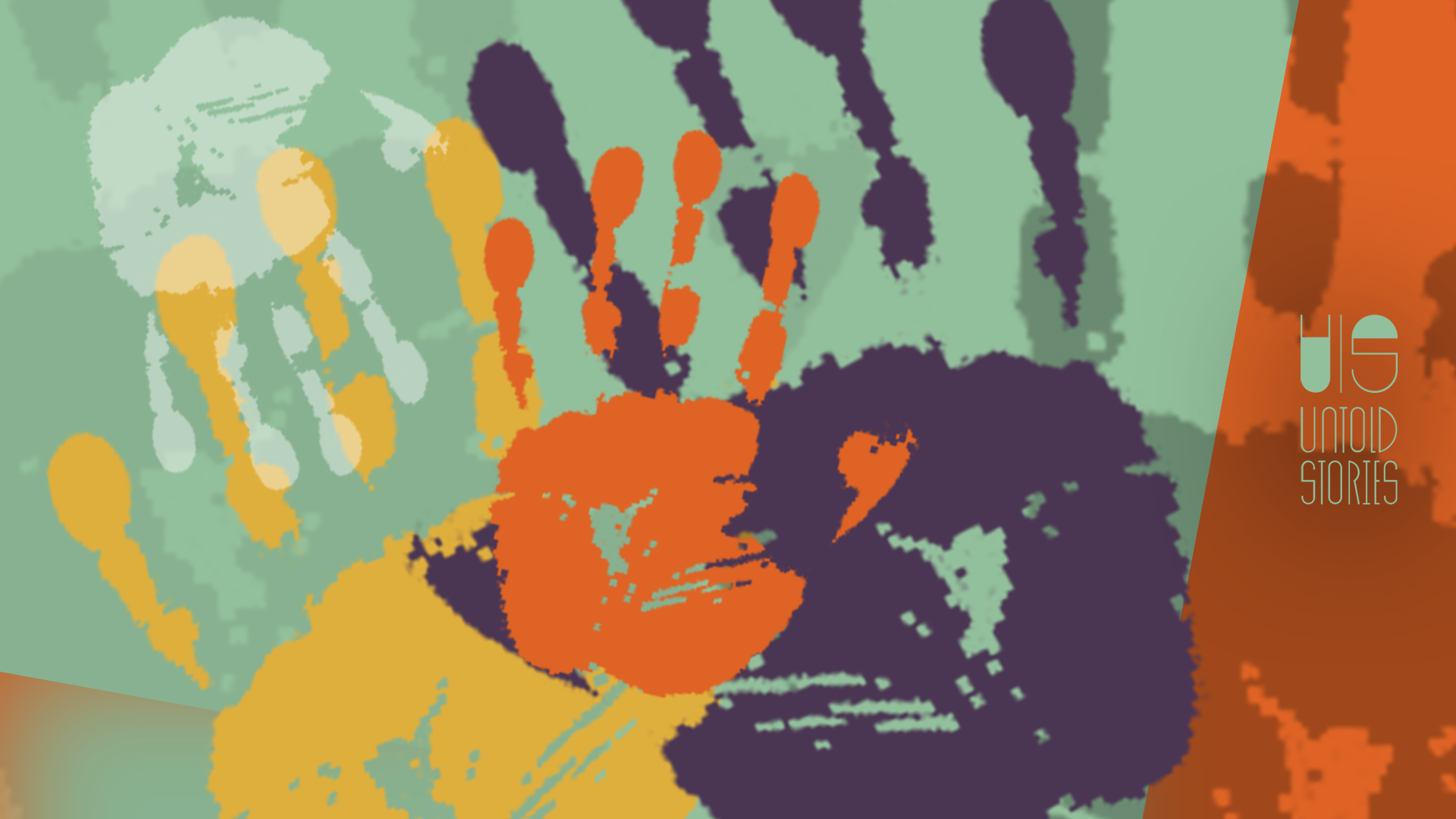ضدّ العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي
الصحافية:آريا حاجي
“تم إنتاج هذه المادة ضمن مشروع «تمكين الجيل القادم من الصحفيات السوريات» بالشراكة بين مؤسستي «شبكة الصحفيات السوريات» و «حكاية ما انحكت». أُنتجت هذه المادة بإشراف الصحافية ميسا صالح“.
“بقرارٍ من والدتي، حُرمتُ من إكمال تعليمي؛ تلك كانت بدايتي مع العنف.”
بهذه الجملة تبدأ لمياء (اسم مستعار) سرد قصّتها، وقد اختارت هذا الاسم رغبةً منها في إخفاء اسمها الحقيقي خوفاً من محيطها المجتمعي. تعيش السيدة الأربعينية النازحة رفقة أحد أطفالها في ريف مدينة القامشلي في شمال شرقي البلاد، وتسعى جاهدةً لتزيل عنها ما خلّفته رحلةً طويلة من العنف والتمييز القائمَين على أساس الجنس؛ رحلةٌ أخذت الكثير من عمرها.
عاشت لمياء مع عائلتها في الكويت حتى أنهت دراستها في المرحلة الابتدائية، ثم عادت العائلة لتستقر في سوريا عقب الاجتياح العراقي للكويت عام ١٩٩٠، وبدأت بإعادة تنظيم أوراقها الثبوتية، ومن ضمنها إعادة الأطفال إلى مقاعد الدراسة. حينها بدأت معاناة لمياء، حين رفضت والدتها عودتها إلى الدراسة، مبرّرة رفضها القطعي بأن “نهاية كل فتاة هو منزل الزوجية”، لذا فما من داعٍ للتعليم، بينما كان موقفها مختلفاً تماماً فيما يتعلق بابنيها، حيث حثّتهما على أن يقوما بإكمال دراستهما.
“ما زلت أذكر ما كان يُشعرني بسوء المعاملة، وهو إجباري على أداء كافة أعمال المنزل دون الاهتمام برفضي المتكرر لذلك، أو بكلمةٍ طيّبة على أقل تقدير.” تقول لمياء وتضيف أن رغبتها الطفولية في أن تخرج للعب مع صديقاتها، ورفضها لأداء المهام المنزلية، عرّضها للتعنيف من قبل شقيقها الأكبر مراتٍ عديدة.
حُرمت لمياء من حقها في ممارسة طفولتها كما تشاء. مثلًا مُنعت بشكلٍ عنيف من صناعة الدمى (كان من المُتعارَفٌ عليه في منطقتها أن تصنع الفتيات الصغيرات دمىً ليلعبن بها). قامت والدتها بتمزيق كلّ دمية صنعتها لمياء في طفولتها، حتى لا تنشغل عن أداء المهام المنزلية.
تُرجع الناشطة النسوية ربى غانم أساس العنف ضد النساء إلى “الاختلالات الجنسية في ميزان القوى”، وتقول لنا إنّ الاعتراف بهذا العنف يسلّط الضوء على الحوادث الناجمة عن التحيّز الجنساني وكره النساء، الذي يُعامل عادةً على أنه سلوكٌ طبيعي.
تضيف ربى أنه يمكن للنساء شأنهنّ شأن الرجال، أن يرتكبن أفعال عنف ضد نساء أخريات سواءً أكان ضمن محيط الأسرة أو العمل أو غيرهما، “وهو ما يمكن اعتباره رد فعل طبيعي على البيئة التي تنتجها السلطة الذكورية، والخصائص الذكورية التي تتصف بها حياة النساء العامة والخاصة”.
تتعدد أشكال العنف ضد النساء والجذور واحدة
بقت لمياء رهينة لأداء الأعمال المنزلية. خلال تلك الفترة، ورغم صغر سنّها، تقدّم لها الكثير من الشبّان لخطبتها لكن العائلة كانت ترفضهم كونها قاصراً.
في ذلك اليوم كانت تبلغ الثامنة عشرة من عمرها. كانت تعود إلى المنزل بعد انتهاء عملها في الفلاحة، وشاهدت والدها وعمّها يقومان بعدّ أموال مهرها. تفاجأت بالأمر، فلم يخبرها أحد بما حدث.
“سألتُ والدتي بطريقة غير مباشرة عمّا يفعله أعمامي ووالدي، وإذا ما كان سبب وجودهم هو شراء أرض أو سيارة؛ كنتُ أعلمُ بالأمر في قرارة نفسي، ولكنني كنتُ أرغب في التأكّد منه، ولم أكن أجرؤ على السؤال المباشر عن الموضوع أو الاعتراض على سبب تزويجي بهذه الطريقة. أجابت والدتي: قام والدك بتزويجك إلى ابن عمّك.”
بعد أن تمّ الزواج، عايشت لمياء نوعاً جديداً من العنف. تقول إنّها عانت كثيرًا، “فلم أحظَ بزوجٍ متفهّم ومثقّف، بل كان يعنّفني على الدوام، لقد كان قاسي الطباع، ويجبرني على القيام بكل الأعمال المنزلية دون أدنى مراعاةٍ لأي ظرفٍ أمرّ به، حتى لو كنت مريضة، فإن الأمر لم يشفع لي يوماً بأن آخذ قسطاً من الراحة.”
عاشت لمياء في منطقة تحكمها الأعراف والعادات والتقاليد، وتتحكم هذه العوامل في مفاصل حيوات النساء، وتمنعهنّ من اتّخاذ أي قرارٍ يمسّ حياتهن العامة والخاصة، لذا فإن إنهاء زواج غير موفّق هو آخر الخيارات التي يمكن أن تفكّر بها لمياء، أو أية امرأة تعيش في ذلك المحيط، سيّما وإن كان الزوج من الأقارب، وزادها حملها بطفلها الأول يقيناً بأن الانفصال أصبح حلماً بعيد المنال.
“أعتقد أن تركّز النشاط المدني القائم على التوعية في المدن، قد تكرّس نتيجة ترسيخ المركزية السياسية في سوريا، لذا نجد أنّه قد تكرّس في لا وعي النخب الثقافية والعاملين في الشأن العام أن العمل المدني ينبغي أن يكون في المدن.” يقول الكاتب والصحفي عباس موسى، مشيراً إلى أنه ينبغي تخصيص كوتا -إن صح التعبير- للريف في مختلف القضايا ومنها هذه القضية.
يعرّف صندوق الأمم المتحدّة للسكان العنف القائم على النوع الاجتماعي وخاصة العنف ضد النساء والفتيات على أنه من أكثر الانتهاكات شيوعاً لحقوق الإنسان في العالم. وهو عنف لا يعرف حدوداً اجتماعية ولا اقتصادية ولا وطنية. وتشير التقديرات العالمية إلى أن امرأة من بين كل ثلاث نساء سوف تتعرض للانتهاك البدني أو الجنسي خلال حياتها. والعنف القائم على النوع الاجتماعي يقوّض الصحة والكرامة والأمان والاستقلالية لدى ضحاياه، ومع ذلك يظل ملتحفاً بثقافة الصمت التي تداريه.
“صارحتُ والدتي بأنني أرغب في الطلاق، لكنها أجابتني أن ضرباً موجعاً ينتظرني من والدي إذا ما علم بالأمر، لم تدعمني البتّة، وكانت سبباً في أنني حملت هماً كبيراً وأنا لم أبلغ العشرين من عمري.”، لكنّها تضيف أن زوجة والدها الثانية دعمتها في قرارها، فقد كانت تتمكن من التأثير في رأي زوجها أكثر ما كانت تفعله والدة لمياء. بعد أن اقتنع والدها، دخلتْ لأول مرة إلى المحكمة لتبدأ بإجراءات الطلاق، وهو ما تم فعلاً.
نساءٌ يُنتهكن بالعنف من جهة وبالوصم الاجتماعي من جهة أخرى
تقول لمياء إن والدتها عاشت يتيمة وكبرت لدى جدتها وأخوالها، وحين تزوجت كان تتعرض للتعنيف المستمر من قبل زوجها، لذا حين رُزقت بلمياء، مارست في حقها كلّ ما مورس عليها بعد أن تزوجت. غالبية النساء اللواتي ينحدرن من المنطقة التي عاشت فيها لمياء ووالدتها، يتعرضن للتعنيف والتمييز بشكل يومي، حيث يُحرمن من التعليم، ويتم تزويجهنّ مبكراً، وذلك نتيجة الحكم والعرف العشائري الذي يطغى على المنطقة، حسب لمياء.
في المرحلة التي تلت الطلاق، باتت لمياء وحيدة في مواجهة أعباء الحياة وتأمين المستلزمات الرئيسية لطفلها، فقد رفضت والدتها في كل مرة ما تطلبه لمياء من مال لشراء دواءٍ أو لباس أو غيرهما لطفلها، لذا قررت الاعتماد على نفسها، وكونها لم تحصل على شهادةٍ علمية، فلم تجد سوى العمل في الفلاحة درباً لتحقيق الاستقلال الاقتصادي. كانت تخرج مع بداية شروق الشمس، وتعود عند مغيبها، رغم ذلك كانت الأعمال المنزلية في انتظارها لدى العودة من الخارج.
أصبحت لمياء المعيلة الوحيدة لطفلها، ومع مرور الوقت، وجدت أنها بحاجة إلى شريكٍ، فتزوجت من شخصٍ اختارته بإرادتها، إلا أنها اكتشفت بعد الزواج منه، أن اختيارها لم يكن صحيحاً البتّة، وقد دفعت ضريبة قرارها ذاك، التزام الصمت وعدم البوح بأية إساءةٍ تتعرض لها من قبل زوجها. أنجبت طفلين خلال رحلة زواجها التي تعرضّت فيها للضرب والتعنيف والهجر والإسقاطات المتكررة، وانتهى الأمر بقيام زوجها بتطليقها بشكل فجائي ودون أي سبب، تقول لمياء.
“رغم أن الطلاق لأول مرة كان خياري، وتعرّضت له لمرة ثانية بشكلٍ تعسفي، إلا أنني دفعت ضريبة كبيرة جرّاء هذا الأمر، فقد حملت وصماً اجتماعياً، ونظرات ريبةٍ واحتقار من محيطي الاجتماعي، لاسيّما النساء منه.” تقول لمياء التي توضّح أنها كابرت على نفسها لأنها ترغب في الاستمرار في الحياة، فقد ملّت الكآبة والحزن اللذان رافقاها من بداية حياتها، وجلّ ما تمنّته هي حياة هانئة خالية من المشاكل والأسى.
الحاجة إلى إجراءاتٌ على مختلف الأصعدة لإنهاء العنف ضد النساء
واجهت لمياء تحدّياتٍ عدة، وما تزال، حيث تعيش برفقة أحد أولادها البالغ من العمر ثماني سنوات، كما أن عائلتها قطعت التواصل بها، ولا يهتمّون لأمرها مطلقاً، مما يجبرها على مواجهة صعوباتٍ جمّة في تأمين المستلزمات الحياتية اليومية.
“لدي طموحٌ في أن أتمكّن من الاستقرار، وأن أستقلّ اقتصادياً؛ أن أتمكّن من شراء منزلٍ أسكنه، وأن يصبح ذاك المنزل بوّابة الأمان الذي لطالما افتقدته.”
تجد الناشطة النسوية ربى غانم أن مناهضة العنف ضد النساء مهمة الجهات الفاعلة والمؤسسات المختلفة التي يجب أن تنسق فيما بينها من أجل ردم الفجوات الجندرية بين الرجال والنساء واتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بحماية حقوق المرأة، من قبيل التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وإلزام الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمناهضته. كما أنه يتعيّن سن قانون وطني وشامل لمناهضة العنف، واعتباره جرماً يعاقَب عليه بعقوبات رادعة، إلى جانب ضرورة إصلاح الإجراءات الإدارية والقضائية هيكلياً لضمان وصول المرأة إلى السلطات والمحاكم للإبلاغ عن أي نوع من أنواع العنف.
تضيف ربى أنه يجب القيام بدراسات كميّة تتناول ظاهرة العنف بجميع أشكاله، للوصول إلى إحصائيات دقيقة وبيانات موثقة حول حوادث العنف وجغرافيتها وأنواعها وهوية مرتكبيها وأعداد النساء الناجيات منها، وغيرها من البيانات التي تساعدنا في الوقوف على حقيقة العنف. “يجب أن تكون هذه الإحصائيات متاحة للجمهور ولا سيما الأكاديميين/ات والسياسيين/ات ومنظمات المجتمع المدني. كما لا بد من إجراء الدراسات النوعية التي تساعد على فهم أشمل لديناميكيات العنف ضد المرأة في، وتوفر أدلة قصصية من خلال توثيق التجارب الشخصية للنساء مع العنف”.
أما الصحافي عباس موسى فإنّه يرى حاجة للوصول إلى عدالة جندرية تتمثّل بالتوعية، وأنّ أهمّ أدواتها هو المدرسة، فإدراج هذه القيم في المناهج والأنشطة في المدرسة ضروري لزرع هذه القيم في الأجيال القادمة. عدا عن ذلك فإن المجتمع بحاجة إلى الوعي بأهمية هذه القضايا عن طريق الأنشطة التي توفّرها المنظمات المدنية، والفسحات الثقافية التي تترك هامشاً كبيراً للتعبير عن مختلف الأفكار وبالتالي توسيع دائرة التأثير.
التجأت لمياء إلى جمعيّة تقدّم الخدمات للنساء حيث تقيم، وتعلّمت من خلالها مهنة الخياطة، كما أنها بدأت التعلّم على كيفية استخدام الحاسوب. تقول إنّها في طريقها لتحقيق استقلالها المادي، “أشعر أنني ما زلت أملك الوقت الكافي لأطوّر من نفسي وأن أكتسب مهاراتٍ جديدة. لا يعني لي شيئاً أنني تجاوزت الأربعين من عمري، فأنا أملك الطاقة الكافية لأن أتعلم الكثير من المهن.”